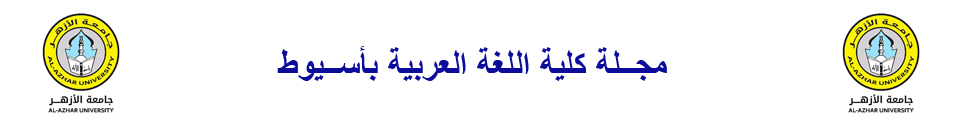
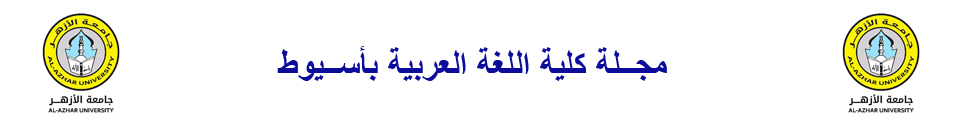
نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
كلية الآداب – جامعة أسيوط
المستخلص
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
([1]) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص149.
([1]) الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي(المتوفى:392هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط4، ج2، ص362.
([1]) دلائل الإعجاز، ص 116.
([1]) التأويل النحوي في القرآن الكريم، عبد الفتاح أحمد الحموز، مكتبة الرشد، الرياض، دون طبعة، 1404ه = 1984م، ج1، ص134. (بتصرف).
([1]) للمزيد يُنظر: الخصائص، ابن جني، ج2، ص36؛ ومغني اللبيب، ابن هشام الأنصاري، ج1، ص822؛ والأشباه والنظائر، ج2، ص49.
([1]) جامع الدروس العربية، ج2، ص150.
([1]) المثل السائر: ٢/٨٩، والبلاغة والتطبيق: ١٩٤.
([1]) [سورة الأحقاف، الآية: 35]. وللمزيد يُنظر: الخصائص، ابن جني، ج2، ص362.
([1]) للمزيد يُنظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ج1، ص153.
([1]) للمزيد يُنظر: الخصائص، ابن جني، ج2، 362.
([1]) للمزيد يُنظر: الإيضاح في علوم البلاغـة، الخطيب القزويني، تحقيق: محمّد عبدالقادر الفاضلي، شركة أبناء شريف الأنصاري للطّباعة والنشر والتوزيع، المكتبة العصرية - صيدا، بيروت ـ لبنان، د.ط، 2009م، ص45. والحذف في النّحو العربيّ، تمام حمد عيد المنيزل، ص77. ومصطفى شاهر خلوف، ص179، 180.
([1]) للمزيد يُنظر: الكتاب، سيبويه، ج2، ص45. والحذف في النّحو العربيّ، تمام حمد عيد المنيزل، ص99. ومصطفى شاهر خلوف، ص190.
([1]) تدخل النّواسـخ على الجملـة الاسمية فتحوّلهـا إلى جملة منسوخـة، سواءً أكانت أفعالا (كان وأخواتها) أم أحرفـا مشبّهة بالفعل؛ فتحصل تحوّلات في الجملة المنسوخة تركيبـا ودلالـة، ولكنّها تحافظ على النّظام العـام للجملة الاسمية؛ فهي تتكـوّن من مسنـد ومسنـد إليه، وهمـا: اسمها وخبـرهـا، ويصيب الحذف أركان الجملة المنسوخة، ومن النّواسخ ما يرفع الأول وينصب الثاني، ومنها ما يبقي الأوّل مرفوعا وينصب الثّـاني، وفي كلتا الحالتين يكون الأوّل اسم ذلك النّاسخ والثّـاني خبره. للمزيد يُنظر: الحذف في النّحو العربيّ، تمام حمد عيد المنيزل، ص77. ومصطفى شاهر خلوف، ص179، 180.
([1]) يقع الحذف في جملة كان وأخواتها فيصيب إمّا فعلها أو اسمها أو خبرهـا، فتحذف كان مع اسمها باطراد ويبقى الخبر، بعد (لـو) و(إن) الشّـرطيتيـن جوازا، كذلك يُحذف اسمها، واسم كان من مرفوعات الأسماء وهو في أصله مبتدأ يكون مع خبره جملة اسمية دخلت عليه إحدى النواسخ، فاحتفظ هو بإعرابه ووقع التغيير على خبره، ويحذف اسم كان من الجملة كما جاء في اللغة العربية بنصوصها والآيات القرآنية وبقية كتب الحديث والآثار فيها الكثير من الجملة التي حذف منها اسم كان، وقد وقع الخلاف بين النحويين حول حذف اسم كان وأخواتها، فذهـب أبـو حيـان إلى عدم جواز حذف اسم كان وأخـواتـها لأنّـه مشبّـه بالفاعل، قال أبو حيان: نص أصحابنا على أنه لا يجوز حذف اسم كان وأخواتها ولا حذف خبرها إلا اختصارًا ولا اقتصارًا أما الاسم فلأنه شبه بالفاعل، أمّــا (لات) فقـد ذهب أكـثـر النّـحويـيـن إلى جواز حذف اسمهـا، إلا أن هذا المنع وجد عكسه وهو أن اسم كان قد حذف في كثير من النصوص". وقـد ذهـب النّـحـاة في جواز عملـهـا فـي مذهـبـيـن: المذهب الأوّل: تعمـل. وممّن أثبت عملهـا نذكر سيبويـه، وقد نقل ابن هشام إجمـاع العـرب على عملـها، إلا أنّ النّحاة اختلـفـوا في ذلك. فقـد ذكر الرّازي أنّ لات لا تدخل إلا على الأحيان، ولا يبرز إلا أحد جزأيـها، إمّـا الاسم وإمّـا الخبـر، وقال سيبويه: تعمل (لات) عمل (ليس)، واسمهـا محذوف وتقديره: (الحينُ)، فيكون التّصـوّر بذلك: لات الحينُ حيـنَ منـاص. والمذهب الثّـانـي: لا تعمـل؛ وهي فيمـا ذكـر مهملة، والاسم الذّي بعدها إن كان مرفوعـا فهو مبتدأ، وإن كان منصوبـا فهو منصوب على إضمار الفعل مثل: لات حين منـاص. فقـدّروا المحذوف بقولهـم: لات أرى حينَ مناصٍ. للمزيد يُنظر: همع الهوامع، ج1، ص116. وجامع الدروس العربية، ج2، ص167- 168.
([1]) اسم ليس من مرفوعات الأسماء وقد وقع محذوفًا حتمًا في الكثير من النصوص العربية. للمزيد يُنظر: همع الهوامع، ج1، ص119. وجامع الدروس العربية، ج2، ص175- 178.
([1]) يعـدّ حذف اسم إنّ وأخواتـهـا أقلّ إذا قورنت بحذف اسم (كان) وأخواتها أو خبرها، وقد جاء اسم إن محذوفًا في الكثير من نصوص العربية سواء أكانت هذه النصوص نثرًا أم شعرًا، واحتدم الخلاف بين بعض النحاة بشأن حذف اسم إن، فقال البعض: إنه لا يحذف إذا كان ضمير الشأن، بينما وُجِدَ الجواز لحذف الاسم بشكل أوسع عند السلسيلي عندما قال: (يجوز حذف الاسم في هذا الباب عند فهم المعنى، ولا يُخصّ بالشعر بل هو فيه أي في الشعر أكثر من النثر، ومن حذفه في النثر ما حكى سيبويه: (إن بك زيدٌ مأخوذٌ)، برفع (زيد)، فالتقديـر: إنّـه زيدٌ بك مأخوذ، والمحذوف هنا ضمير الشّـأن، ولا يخفـى أنّ المحذوف لا يتوقف عليـه إدراك المعنـى دون التّـقـديـر المذكـور. وحكى الأخفش: (إن بك مأخوذٌ أقوالك). وحذفه وهو ضمير الشأن أكثر من حذفه وهو غيره فكذلك قال المصنف: وعليه يُحمل قول النبي -‘-: "إن من أشدِّ الناس عذابًا يوم القيامة المصورون". لا على زيادة (من) خلافًا للكسائي. فالأصل: إنه من أشدِّ الناس، فحذف الاسم وهو ضمير الشأن وإنما تكلف الكسائي زيادة (منْ) لأن مذهبه يمنع حذف الاسم الضمير في مثل هذا التركيب، والسماع يردُّ عليه، وأيضًا فالمعنى يَفْسَدُ على تقدير الزيادة إذ يصير: إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة المصورون، وليس كذلك إذْ غيرهم أشدُّ عذابًا". البخاري، (5606)، ومسلم (2109). والنسائي، كتاب الزينة (5269). وللمزيد يُنظر: شفاء العليل في إيضاح التسهيل، ج1، ص354. والمغني في النحو، ج3، ص150.
([1]) ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الأندلسي، تحقيق: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٤١٨هـ = 1998م، ج3، ص1086.
([1]) سورة يوسف، الآية: 18.
([1]) الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود بن عبدالرحيم صافي (المتوفى: 1376هـ)، دار الرشيد، دمشق – مؤسسة الإيمان، بيروت، ط4، 1418هـ، ج۱۳، ص47.
([1]) جامع الدروس العربية، مصطفى الغلاييني، ص311.
([1]) سورة النمل، الآية: 88.
([1]) علي أبو المكارم، ص251.
([1]) يقوم أسلوب المدح أو الذم كما هو واضح على عناصر ثلاثة ما يهمنا منها، هو المخصوص بالمدح أو الدم، والذي يقصد به الاسم الخاص المعين المذكور بعد الاسم العام (الفاعل)، الذي تمدحه الجملة أو تذمه، وغرضه في التركيب تقوية الحكم وتوكيده، وفي إعرابه أوجه:
الوجه الأول: وهو أن تجعل المخصوص بالمدح أو الذم مبتدأ خبره جملة المدح أو الذم المتقدمة عليه، وفي هذه الحالة كأنك قلت: عبد الله نعم الرجل، لكن الذي يشكل هنا هو أن جملة الخبر ليس فيها ما يعود على المبتدأ، ويرد هذا بقولنا: إن الألف التي تستغرق الجنس قامت مقام العائد. وهذا هو مذهب سيبويه، ولا يجيز غيره.
الوجه الثاني: المخصوص بالمدح أو الذم مبتدأ خبره محذوف وجوبا، وهو مذهب ابن عصفور، قال في شرح التسهيل: "وهو غير صحيح، لأن هذا الحذف لازم، ولم نجد خبرا يلزم حذفه إلا ومحله مشغول بشيء يسد مسده".
الوجه الثالث: وهو الوجه الذي يتسق مع ما ذكرناه عن حالة حذف المبتدأ، ويكون بتقدير المبتدأ وحذفه واجب والمخصوص خبر عنه. وهذا مذهب أبي علي والسيرافي والصيمري"، ويرى ابن هشام أنه إذا حصل حذف في هذا المقام فإنه من باب حذف المبتدأ.
الوجه الرابع: المخصوص بالمدح أو الذم بدل من الفاعل، وهذا مذهب ابن كيسان، وليس البدل بلازم، ثم لأنه لا يصلح لمباشرة نعم أو بئس". ونرى أن البدل هنا فيه نظر؛ لأنه يحدث خللا في تركيب أسلوب المدح أو الذم، وقد يخرجه عن الغرض الذي جاء من أجله.
فهذه الوجوه الأربعة التي تناولت المخصوص بالمدح أو الذم لا تقل من حيث الأهمية بعضها عن بعض، ولك أن تختار ما شئت من هذه المذاهب دون أن تحذف أيًّا منها. ويذهب الباحث إلى ما ذهب إليه ابن عقيل في أن أحسن الآراء وأقربها إلى اليسر هو أن تجعل المخصوص بالمدح أو الذم مبتدأ - تأخر أو تقدم -، وخبره الجملة الفعلية المكونة من فعل المدح وفاعله. للمزيد يُنظر: کتاب الجمل في النحو: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق: د. علي محمد، مؤسسة الرسالة ودار الأمل، ط1، ۱۹۸4م، ص108. والأصول في النحو، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي، تحقيق: عبد الحسنين المفتي، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط1، ۱۹۸5م، ج1، ص112. وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ج۲، ص۱۹۷. وحاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الصبان، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي وشركاه، ج3، ص37. وأوضح المسالك، ابن هشام، ج1، ص154، وج2، ص288. وشرح التصريح على التوضيح، الشيخ خالد الأزهري، ج1، ص177.
([1]) سورة هود، الآية 98.
([1]) سورة هود، الآية 99.
([1]) ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر، ط2، ج3، ص167.
([1]) للمزيد ينظر: العكبري أبو البقاء عبداﷲ بن الحسين، التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط2، 1987م، ج2، ص713.
([1]) علي أبو المكارم، ص251.
([1]) دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ص۱۱۳، وأوضح المسالك ابن هشام، ج1، ص153.
([1]) الحذف في النّحو العربيّ، تمام حمد عيد المنيزل، ص76.
([1]) شرح الكافية، الرضي، ج1، ص117. ويرى الباحثُ أن حالة التشنيع هذه قد تنضوي تحت الذم؛ لأن المشنع به كما في المثال -الغاصب حقي- هو نفسه المخصوص بالذم.
([1]) همع الهوامع، السيوطي، ج1، ص104.
([1]) شرح التصريح على التوضيح، الشيخ خالد الأزهري، ج2، ص117.
([1]) علم اللغة العام - الأصوات -، د. كمال بشر، دار المعارف - مصر، الطبعة السابعة، ۱۹۸۰م، ص193.
([1]) للمزيد ينظر: الحذف في شعر أبي الطيب المتنبي -دراسة نحوية وصفية استقصائية-، زهير محمد عقاب العرود، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد – الأردن، 2004م، ص27.
([1]) علم اللغة العام، د. كمال بشر، ص195.
([1]) للمزيد ينظر: الحذف في شعر أبي الطيب المتنبي -دراسة نحوية وصفية استقصائية-، زهير محمد عقاب العرود، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد – الأردن، 2004م، ص18.
([1]) محمود أبو الوفا، »دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977م، ص21.
([1]) محمود أبو الوفا، »دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977م، ص36.
([1]) محمود أبو الوفا، »دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977م، ص177.
([1]) شعر إبراهيم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهيم ناجي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ، ص24.
([1]) شعر إبراهيم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهيم ناجي، مرجع سابق، ص85.
([1]) شعر إبراهيم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهيم ناجي، مرجع سابق، ص86.
([1]) محمود أبو الوفا، »دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977م، ص16.
([1]) ينظر مصطفى عبد السلام أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكريم، ص43.
([1]) محمود أبو الوفا، »دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977م، ص26 - 27.
([1]) محمود أبو الوفا، »دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977م، ص191.
([1]) محمود أبو الوفا، »دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977م، ص31.
([1]) محمود أبو الوفا، »دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977م، ص85.
([1]) شعر إبراهيم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهيم ناجي، مرجع سابق، ص26.
([1]) شعر إبراهيم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهيم ناجي، مرجع سابق، ص34.
([1]) شعر إبراهيم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهيم ناجي، مرجع سابق، ص34.
([1]) شعر إبراهيم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهيم ناجي، مرجع سابق، ص68.
([1]) شعر إبراهيم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهيم ناجي، مرجع سابق، ص83.
([1]) شعر إبراهيم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهيم ناجي، مرجع سابق، ص84.
([1]) محمود أبو الوفا، »دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977م، ص26 - 27.
([1]) شعر إبراهيم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهيم ناجي، مرجع سابق، ص26.
([1]) الجاثية: 15، فصلت: 46.
([1]) النور: 1.
([1]) جامع الدروس العربية: 2/ 167.
([1]) فيحذف المبتدأ كثيرا في اللاّفتات الإرشادية ولافتات المحلات التجارية وغيرها من العناوين على جوانب الطّرقات وغيرها، على سبيل المثال: عـبـارة (إلى الجامعـة)؛ المبتدأ فيها محـذوف يقـدّر بـ: (الطّريق) أو: (الوجهـة)، فحـذف المبتدأ في الأمثلة السّـابقة لوجود قرينة تدلّ على هذا الحذف. للمزيد يُنظر: الكتاب، سيبويه، ج2، ص129 - 130.
([1]) سورة الأعراف، الآية: 164.
([1]) للمزيد ينظر: الكتاب، سيبويه، ج1، ص384.
([1]) للمزيد ينظر: الكتاب، سيبويه، ج1، ص319 – 320.
([1]) الأعمال الكاملة، محمود حسن إسماعيل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2004م، المجلد الأول، الديوان الأول (أغاني الكوخ)، ص17.
([1]) للمزيد يُنظر: قصيدة كنز الذهب الأبيض (زهرة القطن) -قراءة بلاغية -، د/ تامر محمد أحمد حجازي، مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية، العدد السادس والثلاثون، إصدار ديسمبر 2021م، ص353.
([1]) أروع قصائد أحمد مطر، محفوظ كحوال، نوميديا للطباعة والنشر، ص49.
([1]) أروع قصائد أحمد مطر، محفوظ كحوال، نوميديا للطباعة والنشر، ص24.
([1]) مغنى اللبيب، ابن هشام، تحقيق: د/ مازن المبارك، ج۱، ص۸۲۲ وما بعدها.
([1]) سورة القارعة، الآيتان: 10 ـ 11.
([1]) [سورة الحج، من الآية: 72]. وللمزيد يُنظر: مغني اللبيب، ابن هشام، ج٢، ص٢٥٥.
([1]) أروع قصائد أحمد مطر، محفوظ كحوال، نوميديا للطباعة والنشر، ص352.
([1]) أسرار البلاغة، أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الفارسي، الجرجاني الدار، (المتوفى: 471هـ)، تعليق: محمود محمد شاکر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، ص422. والنحو الوافي، عباس حمس، (المتوفى: ۱۳۹۸ هـ)، دار المعارف، ط15، ج۱، ص276.
([1]) علي أبو المكارم، ص251.
([1]) أروع قصائد أحمد مطر، محفوظ كحوال، نوميديا للطباعة والنشر، ص323.
([1]) فاء الجزاء هي فاء الربط التي جاء بها النحاة لربط جواب الشرط بالشرط المتقدم؛ لأنه لا يصلح أن يكون شرطًا، وقد حدد النحاة هذه المواضع في الآتي:
للمزيد يُنظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، ج2، ص 629؛ والمعجم الوافي في النحو العربي، صنفه: د. علي الحمد، ويوسف جميل الزعبي، منشورات دائرة الثقافة والفنون، عمان - الأردن، ۱۹۸4م، ص320.
([1]) سورة فصلت، من الآية: 46. وسورة الجاثية، من الآية: 15.
([1]) مغني اللبيب، ج2، ص256. وجامع الدروس العربية، الغلاييني، ج2، ص167.
([1]) سورة البقرة، من الآية:220.
([1]) سورة الإسراء، الآية: 7.
([1]) محمود أبو الوفا، »دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977م، ص181.
([1]) سورة يوسف، الآية: 44.
([1]) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش، (المتوفى: ١٤٠٣هـ)، دار الإرشاد للشئون الجامعية، حمص – سورية، ط4، 1415ه، ج4، ص504.
([1]) سورة الفرقان، الآية: 5.
([1]) سورة الأعراف، الآية: 164.
([1]) الكتاب، سيبويه، ج1، ص320
([1]) البيت للمنذر بن درهم الكلبي، وللمزيد يُنظر: الكتاب، سيبويه، ج1، ص161.
([1]) للمزيد يُنظر: الكتاب، سيبويه، ج1، ص320.
([1]) محمود أبو الوفا، »دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه»، مرجع سابق، ص141.
([1]) محمود أبو الوفا، »دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه»، مرجع سابق، ص223.
([1]) محمود أبو الوفا، »دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه»، مرجع سابق، ص237.
([1]) محمود أبو الوفا، »دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه»، مرجع سابق، ص287.
([1]) أروع قصائد أحمد مطر، محفوظ كحوال، نوميديا للطباعة والنشر، ص55.
([1]) النور: 1.
([1]) جامع الدروس العربية: 2/ 167.
([1]) شعر إبراهيم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهيم ناجي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ص25.
([1]) شعر إبراهيم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهيم ناجي، مرجع سابق، ص88.
([1]) أسلوبية الضمائر في ديوان "وراء الغمام" لإبراهيم ناجي، حسام محمد أيوب، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة طيبة، مجلد 25، العدد (1)، 1438ه = 2017م، ص140.
([1]) عروس الأفراح، بهاء الدين السبكي، ج1، ص165.
([1]) شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش، ج2، ص327.
([1]) للمزيد يُنظر: الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، ج2، ص81 – 85؛ وخصائص التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ص241 - 248.
([1]) شرح التسهيل، ابن مالك، ج1، ص131.
([1]) سورة الأحزاب، الآية: 35.
([1]) للمزيد يُنظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج4، ص24.
([1]) سورة طه، الآية: 12.
([1]) شرح الرضي على الكافية، الرضي الإستراباذي، ج3، ص6.
([1]) سورة القدر، الآية: 1.
([1]) سورة البقرة، الآية: 168.
([1]) سورة البقرة، الآيتان: 161 - 162.
([1]) شعر إبراهيم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهيم ناجي، مرجع سابق، ص36.
([1]) شعر إبراهيم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهيم ناجي، مرجع سابق، ص57 - 58.
([1]) ديوان أبي القاسم الشابي، أبو القاسم الشابي، مرجع سابق، ص204.